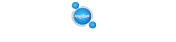إعداديات الريادة: سؤال البناء والقطيعة
قراءة تحليلية في بعض مكونات البرنامج
بقلم: عبد العزيز سنهجي

قراءة تحليلية في بعض مكونات البرنامج
بقلم: عبد العزيز سنهجي
منذ إطلاق برامج إعداديات الريادة، لم يتوقف الجدل العمومي حولها. فقد وضعت هذه التجربة في قلب نقاش وطني واسع، تعددت فيه القراءات، وتباينت حوله المواقف بين دعم رسمي قوي، وتقييم مؤسساتي مشروط، وتحفظ نقابي، وانقسام مجتمعي، ونقد من طرف الخبراء والمهتمين يدعو إلى التريث وربط الاصلاح بالأدلة العلمية والمرجعيات المؤسساتية.
وتجدر الإشارة، أن برامج إعداديات الريادة لا تقوم على مكون واحد، بل ترتكز على عدة مكونات تتفاعل وتتكامل فيما بينها، لعل أهمها: الدعم بالمستوى المناسب (طارل)، والتعليم الصريح، والأنشطة الموازية، وخلايا اليقظة لمحاربة الهدر المدرسي وورشات المهارات النفسية الاجتماعية، إضافة إلى مكونات تنظيمية وبيداغوجية أخرى. غير أن هذا المقال لا يروم تسليط الضوء على البرنامج في شموليته، ولا مناقشة كل هذه المكونات دفعة واحدة، بل يختار التركيز أساسا على مكوني الأنشطة الموازية وخلايا اليقظة، باعتبارهما من أكثر المكونات التي تم معاينتها والاحتكاك بها ميدانيا، على العلم أن باقي المكونات قد نالت حظها من الدراسة والتحليل من طرف مجموعة من الخبراء والمتخصصين، نخص بالذكر منهم الفرنسي فيليب ميريو (Philippe Meirieu)، والكنديين ستيفان ألير (Stéphane Allaire) وستيف بيسونيت (Steve Bissonnette) وآخرون.
فالوزارة الوصية تعتبر مؤسسات الريادة لبنة مركزية في إصلاح المدرسة العمومية، وتقدمها باعتبارها مدخلا لتجويد التعلمات، وتحديث الممارسات البيداغوجية، وتحسين مناخ المؤسسات، مع التأكيد على أن نتائجها تحتاج متسعا زمنيا لتترسخ. في المقابل، شدد المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في خلاصات تقييمه لهذا البرنامج، على وجود مؤشرات ايجابية أولية، لكنه نبه إلى مخاطر اتساع الفوارق المجالية والمؤسساتية، ودعا إلى عدم التسرع في التعميم دون استكمال شروط الانصاف ومستلزمات الحكامة.
أما النقابات التعليمية، فقد طرأ تحول على مواقفها وبدأت تعبر في مجمل بلاغاتها الأخيرة عن تحفظ واضح تجاه طريقة تنزيل المشروع، محذرة من اختلالات بنيوية تمس جوهر الفعل التربوي واستقرار المؤسسات التعليمية، ومن أعباء اضافية متزايدة تثقل كاهل الأطر التربوية والادارية، ومعتبرة أن النموذج المعتمد لم يفتح بما فيه الكفاية مجال الإبداع والاجتهاد داخل المؤسسات، بسبب مركزة اغلب العمليات، وضبط الاجراءات بشكل موحد، والتعامل مع مؤسسات ذات سياقات مختلفة على قدم وساق. كما طالبت بتقييم مستقل، وبمقاربة تشاركية حقيقية، وبربط أي اصلاح بتحسين شروط العمل والموارد داخل المدرسة العمومية.
وعلى مستوى بعض مكونات المجتمع المدني، انقسمت مواقف تمثيليات جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في البداية بين مؤيد ومتحفظ حول بعض الاجراءات، قبل أن تعبر الفيدرالية الوطنية لجمعيات الآباء، في آخر بلاغاتها، عن ترحيبها بالمشروع، ومناشدتها الوزارة الوصية الاستمرار في تعميم تجربة مدارس الريادة حتى تظهر ثمارها للجميع، واعتبارها مبادرة تروم تحسين جودة التعلمات، مع التشديد على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص والانصاف بين المتعلمين والمؤسسات.
وفي السياق نفسه، تباينت مواقف الخبراء والباحثين بين من يثمن منطق التجريب التدريجي والتقييم القائم على التغذية الراجعة وتحصيل معطيات الميدان والتحقق منها، ومن يحذر من تضخيم النتائج أو اختزال إصلاح المدرسة في مشروع واحد، مؤكدا أن نجاح أي نموذج يظل رهينا بصرامة التتبع والتقييم، واستدامة الموارد، وقدرته على معالجة جوهر الأزمة التربوية لا مظاهرها فقط. وفي خضم هذا النقاش، برزت أيضا مواقف تعتبر أن النموذج البيداغوجي المعتمد في إعداديات الريادة يشكل انزياحا عن الإطار المرجعي للإصلاح التربوي، وأن تنزيله اعتمد منطق المركزة والتنميط والاختزال بدل منطق النجاعة والابتكار والانفتاح.
وسط هذا التباين المشروع في المواقف، تبرز الحاجة إلى التمييز بين النقاش حول البرنامج في شموليته، وبين تقييم بعض مكوناته التي أفرزت ممارسات واعدة على المستوى الميداني. وفي هذا الإطار، ورغم تزايد المواقف الرافضة لبرامج إعداديات الريادة، ورغم الانتقادات الموجهة لبعض مكونات هذه البرامج، ورغم ما قد تشعر به بعض الفئات من حيف مرتبط بعدم الاعتراف الكافي بمجهوداتها، لا يمكن انكار أن التجربة واجهت اكراهات وصعوبات، سواء على مستوى الموارد البشرية، أو الموارد اللوجستيكية، أو الإكراهات المرتبطة بتدبير الزمن المدرسي وتهيئة الفضاءات، والاكتظاظ المسجل في بعض المؤسسات.
غير أن ما يستحق التنويه هو أن عددا مهما من المؤسسات انخرط في هذا التمرين بشكل تدريجي، وبدأت تتعلم من اخطائها، ونجحت في إحداث تحول ملموس في بعض مكونات البرامج، وفي مناخ المؤسسة وعلاقتها بالمتعلمين. وهو ما يجعل من غير المنصف اختزال التجربة في بعض تعثراتها الأولى أو في بعض اختلالات تنزيلها، دون استحضار الدينامية المهنية التي خلقتها داخل عدد من المؤسسات، وما أفرزته من مبادرات محلية وتعلم جماعي وتراكم تدريجي لخبرات ميدانية بدأت تنعكس على صورة المؤسسة وعلى علاقة المتعلم بالمدرسة.
ومن خلال قراءة تربوية متأنية لما تحقق داخل عدد من المؤسسات، يبرز أن من بين أهم ما أفرزته هذه التجربة مكوني الأنشطة الموازية وخلايا اليقظة الخاصة بمحاربة الهدر المدرسي. هذا الموقف لا يعكس انطباعا مزاجيا، بل يستند إلى معاينة ميدانية لما راكمته هاتان الآليتان من مؤشرات ايجابية. صحيح أن الأنشطة الموازية وخلايا اليقظة ليستا جديدتين في المرجعيات التربوية، وقد عرفتهما المنظومة في محطات متعددة، لكن الجديد اليوم يكمن في الكثافة والعمق التي فعلتا بها، وفي المنهجية المؤطرة لهما، وفي الرهان الوظيفي الواضح الذي اسند اليهما داخل المؤسسة التعليمية.
فالأنشطة الموازية، حين تفعل ضمن تصور منهاجي منظم، قائم على امتلاك المنشطين، سواء كانوا داخليين أو خارجيين، لكفايات التنشيط التربوي، واستراتيجيات التعلم النشيط، وبيداغوجيا المشروع، وقدرتهم على تصميم وتقديم وضعيات - تعلم إدماجية وذات دلالة، واستحضار المقاربة بالكفايات في بناء وتملك الموارد المعرفية والمهارية والقيمية، فإنها لا تشتغل على هامش التعلمات، بل تقع في عمقها وسيرورتها، وتمس صميم وظيفة المؤسسة التربوية. إنها تعيد الاعتبار للمؤسسة كفضاء للحياة، وللمتعلم كذات فاعلة متعددة الأبعاد.
داخل هذه الأنشطة يستعيد المتعلم صوته، ويكتشف قدراته، ويتعلم العمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، وبناء الثقة في الذات، كما تسهم في تنمية تملكه للكفايات النفسية والاجتماعية. وهي كفايات مستعرضة ومهارات حياتية لا تبنى داخل الفصل الدراسي وحده، ولا تقاس بالامتحانات، لكنها تصنع الفارق الحقيقي في علاقة المتعلم بالمدرسة وبمحيطها الاجتماعي العام، وفي قدرته على الاستمرار والنجاح. يكفي أن تلج بعض إعداديات الريادة لتصادف ورشات للمسرح والارتجال، والموسيقى والتشكيل والفلك، والتفتح العلمي، والكتابة الإبداعية، والمناظرة، والتربية على المواطنة والمقاولة، لتدرك أنك أمام مؤسسة تحاول جاهدة أن تنفتح على الحياة، لا مدرسة تنفيذ المقررات وتلقين المعلومات فقط.
وبالموازاة، مع ذلك، جسدت خلايا اليقظة تحولا نوعيا في منطق الاشتغال التربوي، حيث تم الانتقال من ثقافة التدخل بعد حدوث الهدر إلى ثقافة الوقاية والاستباق والرصد المبكر. انتقال من انتظار الفشل والانقطاع كقدر محتوم، إلى رصدهما في مراحلهما الأولى، وفهم أسبابهما النفسية والاجتماعية والتربوية، والتعامل معهما بمقاربات مواكبة فردية ذات طابع علاجي ووقائي وتنموي. هذا المنطق الذي يراد تكريسه اليوم في واقع المؤسسات التعليمية، مهما تغيرت البرامج والمسميات، يظل ضرورة بنيوية لكل مؤسسة تعليمية تسعى فعلا إلى حماية متعلميها من الاقصاء والهدر الصامت.
وتكتسي أهمية هذين المكونين بعدا إضافيا حين نستحضر أن كلفتهما تبقى معقولة مقارنة بما يحققانه من أثر تربوي. فهما لا يتطلبان ميزانيات ضخمة بقدر ما يتطلبان وضوحا في الرؤية، وتنظيما منهجيا محكما، وثقافة عمل جماعي داخل المؤسسة. ومع ذلك، فقد أسهما في تقليص مظاهر ومؤشرات الهدر المدرسي، وتحسين المناخ المدرسي، وتعزيز الدافعية والانتماء، والحد من بعض السلوكيات السلبية. وهي نتائج قد لا تعكسها دائما الاحصائيات، لكنها تلمس بوضوح في الحياة اليومية للمؤسسة وفي علاقة المتعلمين بفضاءاتها.
كما لا يمكن اغفال الرصيد المهني الذي راكمته الأطر التربوية والإدارية من خلال الاشتغال على هذين المكونين. فقد تعلم الفاعلون العمل بمنطق الفريق، والتنسيق الأفقي والعمودي بين التدخلات، وقراءة وضعيات المتعلمين قراءة شمولية لا تختزلهم في النتائج الدراسية فقط، بل تنظر في الجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية المتفاعلة ضمن النسق الإيكولوجي للمتعلم. وعليه، فإن التفريط في هذا التراكم، تحت أي ذريعة، يشكل هدرا لخبرة ميدانية ثمينة، قبل أن يكون تراجعا عن اختيار تربوي يبقى دائما في حاجة للتقييم والمساءلة المجتمعية.
صحيح أيضا، وبناء على تجارب سابقة، يمكن للزمن السياسي أن يضغط على الزمن التربوي، وقد يفضي إلى التخلي عن هذه التجربة أو تجميدها. لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل سيتشبث الفاعلون بهذا الرصيد من التجارب الإيجابية، ويحافظون على ما تحقق من إنجازات، ويطورونه بما يلزم من نقد وتصحيح، أم سيتم التملص من كل هذا التراكم والعودة إلى نقطة الصفر؟
الأيام المقبلة، وحدها، كفيلة بالكشف عن مصير هذه التجربة، وعن مدى قدرة صناع القرار والفاعلين التربويين على تغليب منطق البناء والاستمرارية على منطق القطيعة والمزايدات الظرفية. وفي كل الأحوال، يبقى الرهان الأساسي هو مصلحة المتعلم، وجودة المدرسة العمومية، واستدامة كل مبادرة تثبت، مهما كانت إكراهاتها، أنها تحدث فرقا حقيقيا داخل الفصول الدراسية والمؤسسات التعليمية.
وضمن هذا المنطلق، فإن النقاش العمومي حول مؤسسات الريادة لا ينبغي أن يختزل في ثنائية القبول أو الرفض، بل أن يعاد توجيهه نحو سؤال جوهري: ماذا يخدم المتعلم فعلا؟ وما الذي ينبغي تثبيته وتطويره وتصحيحه؟ فحين نراجع السياسات لا نمحو ما نجح منها، بل نبني عليه. والأنشطة الموازية وخلايا اليقظة ليستا خيارين ظرفيين مرتبطين ببرنامج بعينه، بل ركيزتين أساسيتين لمدرسة نريدها مفعمة بالحياة، دامجة، ومنصفة، تؤمن بأن المتعلم قادر على النجاح متى وجد من يصغي إليه ويواكبه بيداغوجيا ونفسيا واجتماعيا.
وتجدر الإشارة، أن برامج إعداديات الريادة لا تقوم على مكون واحد، بل ترتكز على عدة مكونات تتفاعل وتتكامل فيما بينها، لعل أهمها: الدعم بالمستوى المناسب (طارل)، والتعليم الصريح، والأنشطة الموازية، وخلايا اليقظة لمحاربة الهدر المدرسي وورشات المهارات النفسية الاجتماعية، إضافة إلى مكونات تنظيمية وبيداغوجية أخرى. غير أن هذا المقال لا يروم تسليط الضوء على البرنامج في شموليته، ولا مناقشة كل هذه المكونات دفعة واحدة، بل يختار التركيز أساسا على مكوني الأنشطة الموازية وخلايا اليقظة، باعتبارهما من أكثر المكونات التي تم معاينتها والاحتكاك بها ميدانيا، على العلم أن باقي المكونات قد نالت حظها من الدراسة والتحليل من طرف مجموعة من الخبراء والمتخصصين، نخص بالذكر منهم الفرنسي فيليب ميريو (Philippe Meirieu)، والكنديين ستيفان ألير (Stéphane Allaire) وستيف بيسونيت (Steve Bissonnette) وآخرون.
فالوزارة الوصية تعتبر مؤسسات الريادة لبنة مركزية في إصلاح المدرسة العمومية، وتقدمها باعتبارها مدخلا لتجويد التعلمات، وتحديث الممارسات البيداغوجية، وتحسين مناخ المؤسسات، مع التأكيد على أن نتائجها تحتاج متسعا زمنيا لتترسخ. في المقابل، شدد المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في خلاصات تقييمه لهذا البرنامج، على وجود مؤشرات ايجابية أولية، لكنه نبه إلى مخاطر اتساع الفوارق المجالية والمؤسساتية، ودعا إلى عدم التسرع في التعميم دون استكمال شروط الانصاف ومستلزمات الحكامة.
أما النقابات التعليمية، فقد طرأ تحول على مواقفها وبدأت تعبر في مجمل بلاغاتها الأخيرة عن تحفظ واضح تجاه طريقة تنزيل المشروع، محذرة من اختلالات بنيوية تمس جوهر الفعل التربوي واستقرار المؤسسات التعليمية، ومن أعباء اضافية متزايدة تثقل كاهل الأطر التربوية والادارية، ومعتبرة أن النموذج المعتمد لم يفتح بما فيه الكفاية مجال الإبداع والاجتهاد داخل المؤسسات، بسبب مركزة اغلب العمليات، وضبط الاجراءات بشكل موحد، والتعامل مع مؤسسات ذات سياقات مختلفة على قدم وساق. كما طالبت بتقييم مستقل، وبمقاربة تشاركية حقيقية، وبربط أي اصلاح بتحسين شروط العمل والموارد داخل المدرسة العمومية.
وعلى مستوى بعض مكونات المجتمع المدني، انقسمت مواقف تمثيليات جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في البداية بين مؤيد ومتحفظ حول بعض الاجراءات، قبل أن تعبر الفيدرالية الوطنية لجمعيات الآباء، في آخر بلاغاتها، عن ترحيبها بالمشروع، ومناشدتها الوزارة الوصية الاستمرار في تعميم تجربة مدارس الريادة حتى تظهر ثمارها للجميع، واعتبارها مبادرة تروم تحسين جودة التعلمات، مع التشديد على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص والانصاف بين المتعلمين والمؤسسات.
وفي السياق نفسه، تباينت مواقف الخبراء والباحثين بين من يثمن منطق التجريب التدريجي والتقييم القائم على التغذية الراجعة وتحصيل معطيات الميدان والتحقق منها، ومن يحذر من تضخيم النتائج أو اختزال إصلاح المدرسة في مشروع واحد، مؤكدا أن نجاح أي نموذج يظل رهينا بصرامة التتبع والتقييم، واستدامة الموارد، وقدرته على معالجة جوهر الأزمة التربوية لا مظاهرها فقط. وفي خضم هذا النقاش، برزت أيضا مواقف تعتبر أن النموذج البيداغوجي المعتمد في إعداديات الريادة يشكل انزياحا عن الإطار المرجعي للإصلاح التربوي، وأن تنزيله اعتمد منطق المركزة والتنميط والاختزال بدل منطق النجاعة والابتكار والانفتاح.
وسط هذا التباين المشروع في المواقف، تبرز الحاجة إلى التمييز بين النقاش حول البرنامج في شموليته، وبين تقييم بعض مكوناته التي أفرزت ممارسات واعدة على المستوى الميداني. وفي هذا الإطار، ورغم تزايد المواقف الرافضة لبرامج إعداديات الريادة، ورغم الانتقادات الموجهة لبعض مكونات هذه البرامج، ورغم ما قد تشعر به بعض الفئات من حيف مرتبط بعدم الاعتراف الكافي بمجهوداتها، لا يمكن انكار أن التجربة واجهت اكراهات وصعوبات، سواء على مستوى الموارد البشرية، أو الموارد اللوجستيكية، أو الإكراهات المرتبطة بتدبير الزمن المدرسي وتهيئة الفضاءات، والاكتظاظ المسجل في بعض المؤسسات.
غير أن ما يستحق التنويه هو أن عددا مهما من المؤسسات انخرط في هذا التمرين بشكل تدريجي، وبدأت تتعلم من اخطائها، ونجحت في إحداث تحول ملموس في بعض مكونات البرامج، وفي مناخ المؤسسة وعلاقتها بالمتعلمين. وهو ما يجعل من غير المنصف اختزال التجربة في بعض تعثراتها الأولى أو في بعض اختلالات تنزيلها، دون استحضار الدينامية المهنية التي خلقتها داخل عدد من المؤسسات، وما أفرزته من مبادرات محلية وتعلم جماعي وتراكم تدريجي لخبرات ميدانية بدأت تنعكس على صورة المؤسسة وعلى علاقة المتعلم بالمدرسة.
ومن خلال قراءة تربوية متأنية لما تحقق داخل عدد من المؤسسات، يبرز أن من بين أهم ما أفرزته هذه التجربة مكوني الأنشطة الموازية وخلايا اليقظة الخاصة بمحاربة الهدر المدرسي. هذا الموقف لا يعكس انطباعا مزاجيا، بل يستند إلى معاينة ميدانية لما راكمته هاتان الآليتان من مؤشرات ايجابية. صحيح أن الأنشطة الموازية وخلايا اليقظة ليستا جديدتين في المرجعيات التربوية، وقد عرفتهما المنظومة في محطات متعددة، لكن الجديد اليوم يكمن في الكثافة والعمق التي فعلتا بها، وفي المنهجية المؤطرة لهما، وفي الرهان الوظيفي الواضح الذي اسند اليهما داخل المؤسسة التعليمية.
فالأنشطة الموازية، حين تفعل ضمن تصور منهاجي منظم، قائم على امتلاك المنشطين، سواء كانوا داخليين أو خارجيين، لكفايات التنشيط التربوي، واستراتيجيات التعلم النشيط، وبيداغوجيا المشروع، وقدرتهم على تصميم وتقديم وضعيات - تعلم إدماجية وذات دلالة، واستحضار المقاربة بالكفايات في بناء وتملك الموارد المعرفية والمهارية والقيمية، فإنها لا تشتغل على هامش التعلمات، بل تقع في عمقها وسيرورتها، وتمس صميم وظيفة المؤسسة التربوية. إنها تعيد الاعتبار للمؤسسة كفضاء للحياة، وللمتعلم كذات فاعلة متعددة الأبعاد.
داخل هذه الأنشطة يستعيد المتعلم صوته، ويكتشف قدراته، ويتعلم العمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، وبناء الثقة في الذات، كما تسهم في تنمية تملكه للكفايات النفسية والاجتماعية. وهي كفايات مستعرضة ومهارات حياتية لا تبنى داخل الفصل الدراسي وحده، ولا تقاس بالامتحانات، لكنها تصنع الفارق الحقيقي في علاقة المتعلم بالمدرسة وبمحيطها الاجتماعي العام، وفي قدرته على الاستمرار والنجاح. يكفي أن تلج بعض إعداديات الريادة لتصادف ورشات للمسرح والارتجال، والموسيقى والتشكيل والفلك، والتفتح العلمي، والكتابة الإبداعية، والمناظرة، والتربية على المواطنة والمقاولة، لتدرك أنك أمام مؤسسة تحاول جاهدة أن تنفتح على الحياة، لا مدرسة تنفيذ المقررات وتلقين المعلومات فقط.
وبالموازاة، مع ذلك، جسدت خلايا اليقظة تحولا نوعيا في منطق الاشتغال التربوي، حيث تم الانتقال من ثقافة التدخل بعد حدوث الهدر إلى ثقافة الوقاية والاستباق والرصد المبكر. انتقال من انتظار الفشل والانقطاع كقدر محتوم، إلى رصدهما في مراحلهما الأولى، وفهم أسبابهما النفسية والاجتماعية والتربوية، والتعامل معهما بمقاربات مواكبة فردية ذات طابع علاجي ووقائي وتنموي. هذا المنطق الذي يراد تكريسه اليوم في واقع المؤسسات التعليمية، مهما تغيرت البرامج والمسميات، يظل ضرورة بنيوية لكل مؤسسة تعليمية تسعى فعلا إلى حماية متعلميها من الاقصاء والهدر الصامت.
وتكتسي أهمية هذين المكونين بعدا إضافيا حين نستحضر أن كلفتهما تبقى معقولة مقارنة بما يحققانه من أثر تربوي. فهما لا يتطلبان ميزانيات ضخمة بقدر ما يتطلبان وضوحا في الرؤية، وتنظيما منهجيا محكما، وثقافة عمل جماعي داخل المؤسسة. ومع ذلك، فقد أسهما في تقليص مظاهر ومؤشرات الهدر المدرسي، وتحسين المناخ المدرسي، وتعزيز الدافعية والانتماء، والحد من بعض السلوكيات السلبية. وهي نتائج قد لا تعكسها دائما الاحصائيات، لكنها تلمس بوضوح في الحياة اليومية للمؤسسة وفي علاقة المتعلمين بفضاءاتها.
كما لا يمكن اغفال الرصيد المهني الذي راكمته الأطر التربوية والإدارية من خلال الاشتغال على هذين المكونين. فقد تعلم الفاعلون العمل بمنطق الفريق، والتنسيق الأفقي والعمودي بين التدخلات، وقراءة وضعيات المتعلمين قراءة شمولية لا تختزلهم في النتائج الدراسية فقط، بل تنظر في الجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية المتفاعلة ضمن النسق الإيكولوجي للمتعلم. وعليه، فإن التفريط في هذا التراكم، تحت أي ذريعة، يشكل هدرا لخبرة ميدانية ثمينة، قبل أن يكون تراجعا عن اختيار تربوي يبقى دائما في حاجة للتقييم والمساءلة المجتمعية.
صحيح أيضا، وبناء على تجارب سابقة، يمكن للزمن السياسي أن يضغط على الزمن التربوي، وقد يفضي إلى التخلي عن هذه التجربة أو تجميدها. لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل سيتشبث الفاعلون بهذا الرصيد من التجارب الإيجابية، ويحافظون على ما تحقق من إنجازات، ويطورونه بما يلزم من نقد وتصحيح، أم سيتم التملص من كل هذا التراكم والعودة إلى نقطة الصفر؟
الأيام المقبلة، وحدها، كفيلة بالكشف عن مصير هذه التجربة، وعن مدى قدرة صناع القرار والفاعلين التربويين على تغليب منطق البناء والاستمرارية على منطق القطيعة والمزايدات الظرفية. وفي كل الأحوال، يبقى الرهان الأساسي هو مصلحة المتعلم، وجودة المدرسة العمومية، واستدامة كل مبادرة تثبت، مهما كانت إكراهاتها، أنها تحدث فرقا حقيقيا داخل الفصول الدراسية والمؤسسات التعليمية.
وضمن هذا المنطلق، فإن النقاش العمومي حول مؤسسات الريادة لا ينبغي أن يختزل في ثنائية القبول أو الرفض، بل أن يعاد توجيهه نحو سؤال جوهري: ماذا يخدم المتعلم فعلا؟ وما الذي ينبغي تثبيته وتطويره وتصحيحه؟ فحين نراجع السياسات لا نمحو ما نجح منها، بل نبني عليه. والأنشطة الموازية وخلايا اليقظة ليستا خيارين ظرفيين مرتبطين ببرنامج بعينه، بل ركيزتين أساسيتين لمدرسة نريدها مفعمة بالحياة، دامجة، ومنصفة، تؤمن بأن المتعلم قادر على النجاح متى وجد من يصغي إليه ويواكبه بيداغوجيا ونفسيا واجتماعيا.
عبد العزيز سنهجي - يناير 2026