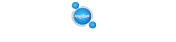العنف المدرسي بالمغرب
حوار مع الباحث والمؤطر التربوي، الأستاذ عبد العزيز سنهجي (خبير تربوي)
جريدة العلم الاسبوعي العدد 26055 من الجمعة 04 يوليوز إلى الخميس 10 يوليوز 2025

حوار مع الباحث والمؤطر التربوي، الأستاذ عبد العزيز سنهجي (خبير تربوي)
جريدة العلم الاسبوعي العدد 26055 من الجمعة 04 يوليوز إلى الخميس 10 يوليوز 2025
1. كيف تُعرِّفون العنف المدرسي، وما هي أبرز تمظهراته داخل الفضاء التربوي؟
العنف المدرسي هو كل سلوك فردي أو جماعي يتسم بالعدوانية ويخل بالاحترام المتبادل داخل المؤسسة التعليمية، استنادا إلى نظامها الداخلي ومواثيقها في العمل، سواء كان موجها من التلميذ أو الأستاذ أو الإدارة أو الأسرة في بعض الأحيان.
ويشمل العنف اللفظي مثل: (سب، شتم، إهانة، تهديد، تنمر...)، والجسدي مثل: (ضرب، دفع، ركل، خنق، صفع...)، والرمزي مثل: (الإقصاء، التهميش، التمييز، التجاهل...)، والرقمي مثل: (نشر صور، تنمر إلكتروني، تشهير...).
أما تمظهراته فهي كثيرة ومتعددة، قد تكون رمزية في بعض الأحيان وتصل أحيانا أخرى إلى تمظهرات مادية، تتعدد أشكال وصيغ ممارستها، وتتنوع الجهات التي يقع عليها فعل العنف، فنجد مثلا عنفا بين التلاميذ، أو ضد الأساتذة أو بين بعضهم البعض، أو عنف الإدارة ضد التلاميذ، أو عنف الإدارة تجاه الأساتذة، أو الأسر تجاه الإدارة...
2. ما أبرز الأسباب البنيوية والاجتماعية التي تغذي هذه الظاهرة؟
إن سلوك العنف، الذي نشهده اليوم في مؤسساتنا عبر ربوع الوطن، عبارة عن ردة فعل إزاء واقع مرفوض ومتناقض مع الرغبات الذاتية أو الجماعية، بغض النظر عن مشروعية تلك الرغبات. ويعكس هذا السلوك نوعا من عدم الاعتراف بالعلاقات البيداغوجية وبأشكال السلطة التربوية كما هي ممأسسة ومنظمة ضمن إطار قانوني وتنظيمي.
إن العنف المدرسي، سواء كفعل أو كردة فعل، تتقاطع ضمنه مجموعة من العوامل: منها ما هو ذاتي، يحيل إلى التركيبة النفسية والبيولوجية والمعرفية للفرد، ومنها ما هو موضوعي، يحيل إلى المعطيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية.
ولا يمكن فهم هذه الظاهرة إلا بوضعها في سياقها الاجتماعي العام بأبعاده المختلفة، فالظاهرة تختلف حدتها وتمظهراتها باختلاف السياقات والأزمنة والأوساط المدرسية... ومن الطبيعي جدا أن تبرز هناك اختلافات وتضارب في وجهات النظر حول تفسير ومعالجة ظاهرة العنف المدرسي، لأن موضوع هذه الظاهرة هو الفرد، سواء كان تلميذا أو أستاذا أو إداريا... وهو ما يجعل منها ظاهرة إنسانية، تُنسج إما ذاتيا أو بتفاعل الذات مع مكونات المحيط الاجتماعي، حيث يمكن مقاربتها سواء بإعمال المنظورات الفردانية أو المنظورات الاجتماعية.
إلا أنه، في اعتقادي، ولكي تكون مقارباتنا مفيدة وإجرائية، لا بد أن تمتح من المنظور التكاملي الذي يجمع بين الجانب السيكولوجي والجانب الاجتماعي العام، مستحضرين في ذلك منطق الديناميات والتفاعلات الذي يجمع بين البعدين معا في زمان ومكان محددين. إن المقاربة النسقية تخبرنا بأن العنف داخل المدرسة ليس مجرد فعل معزول، بل نتاج لضعف التفاعل بين بنيات التنشئة الاجتماعية، وبنيات التأطير والمواكبة، وأزمات التماسك المجتمعي.
3. هل توافقون طرح أن تفشي العنف يعكس اختلالات أعمق في البنية المجتمعية؟ وكيف نفكك هذه الميكانيزمات؟
بكل تأكيد، إن تفشي العنف المدرسي ليس ظاهرة اجتماعية معزولة، بل يعكس اختلالات أعمق في البنية المجتمعية. فالعنف يتجذر في السياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعيد إنتاج اللامساواة والتهميش والضغط النفسي والإقصاء الاجتماعي.
وقد تناول عدد من المفكرين هذه المسألة من زوايا متعددة؛ حيث يرى بيير بورديو أن العنف الرمزي الذي تمارسه المؤسسات (كالمدرسة والإعلام) يكرّس الهيمنة ويعيد إنتاج الفوارق الاجتماعية ويحافظ على الوضع الاجتماعي بطبقاته وتمايزاته، أما إميل دوركايم فيربط بين غياب وضع لمعايير اجتماعية والعنف، بوصفه نتيجة لفقدان التوازن بين الفرد والمجتمع، ويحلل ميشال فوكو العنف بوصفه جزءا من آليات السلطة والرقابة التي تنتج أجسادا وعقولا مطيعة في المؤسسات.
ولهذا، فإن تفكيك ميكانيزمات العنف يمر عبر تحليل البنية الاجتماعية العامة، من خلال كشف علاقات السلطة، ونقد الأنظمة التعليمية والإعلامية، والتصدي للخطابات الإقصائية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. إن العنف، إذن، ليس سلوكا منحرفا فقط، بل هو مؤشر على أزمة بنيوية عميقة تتطلب إصلاحا شاملا يطال القيم والمؤسسات والفرص المتاحة للأفراد والجماعات.
وأعتقد أن تفكيك هذه الميكانيزمات، خاصة في علاقتها بالمؤسسة التعليمية، يمر بالضرورة عبر: دمقرطة الحياة المدرسية بتمكين المتعلمين من التعبير والمشاركة الفعلية في مشاريع المدرسة، وتأهيل الفرق التربوية لفهم العوامل والأسباب المغذية للعنف كسلوك يحتاج إلى معالجة نفسية وتربوية، وليس بالضرورة تأديبية، مع تنشيط آلية الوساطة المدرسية كآلية لحل النزاعات بشكل تربوي، والحرص على تحفيز المتعلمين على بناء مشاريع شخصية تعزز الشعور بالمعنى والانتماء، والتنسيق مع الأسر عبر مشاريع مؤسسية مشتركة للوقاية من العنف.
4. كيف تقرؤون نسب العنف في دراسات المجلس الأعلى للتربية؟ وماذا تعكس؟
أعتقد أن هذه الأرقام المقدمة في الدراسة المنجزة من طرف المجلس الأعلى ليست مجرد معطيات إحصائية، تبرز نسب العنف المرتفعة داخل المدرسة، ولا يمكن قراءة هذه المعطيات إلا من خلال منظور سوسيولوجي شمولي، يضع المدرسة في سياقها المجتمعي والثقافي والسياسي...إن الأرقام المقدمة إشارة واضحة لاختلالات بنيوية عميقة في النظام التربوي، وتعبير صريح عن توتر في العلاقة بين الفاعلين داخل المدرسة، وهشاشة بدأت تطال الإطار القيمي، والمشروع التربوي المشترك، وتآكل في السلطة التربوية. ولمواجهة هذا الواقع غير السوي، يتطلب الأمر مراجعة جذرية لهوية المدرسة، ولموقعها داخل المشروع المجتمعي العام. فحين تخفق المدرسة في أن تكون مجتمعا مصغرا للعدالة، فإنها تصبح مختبرا لإنتاج وإعادة إنتاج العنف. وهنا تبرز الحاجة إلى مقاربة شمولية تعيد الاعتبار لدور المدرسة ووظيفتها وعلاقتها بالبناء الاجتماعي العام، من خلال تأهيل الفاعلين والشركاء، وتطوير النموذج البيداغوجي، وتعزيز ثقافة الحوار، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والوساطة، بما يجعل من المدرسة فضاء آمنا للعيش المشترك، والتعلم، وبناء المواطنة.
5. هل تُعد الاعتداءات على الأطر التربوية مؤشرًا على فشل المدرسة في ترسيخ ثقافة الاحترام؟
نعم، وبكل تأكيد، عندما تغيب ثقافة الحوار، والمسؤولية، والالتزام، والقيم المشتركة، فهذا يؤشر على فشل المدرسة في تجسيد تربية وجدانية وأخلاقية فعالة. لكن هذا الفشل لا يجوز تحميل مسؤوليته للمدرسة فقط، بل يشمل ضعف التنسيق والتعاون بين المدرسة والأسرة ومؤسسات الإعلام وبنيات المجتمع. وأعتقد أنه مهما كانت المسؤوليات، فإننا بدأنا نشهد في السنوات الأخيرة تراجعا في الوضعية الاعتبارية للفاعل التربوي، وتقليصا في دوره التربوي، بالإضافة إلى التحولات التي طالت صورة المدرسة ووظيفتها، بحيث لم تعد ذلك المصعد الاجتماعي الذي يؤمّن الترقي الفردي والمجتمعي والحراك المهني. والتحدي الذي يواجهنا كدولة ومجتمع هو: كيف يمكن أن نعيد تأسيس مدرسة القيم والاحترام، لا مدرسة العقاب والخوف، في ظل سياقات الإصلاح التربوي المأمول.
6. إلى أي حد يسهم غياب الردع القانوني وسهولة الوصول إلى أدوات حادة في تكريس مناخ غير آمن؟
بكل تأكيد، غياب الردع القانوني الفعّال يضعف سلطة المؤسسة الرمزية، لكن الأهم، في تقديري، هو غياب آليات الوقاية والاستشعار المبكر داخل المدرسة.
وعليه، فإن الرهان ينبغي أن يكون على إعادة تنظيم التعاقد بين مختلف الفاعلين من خلال تحديد منظومة الحقوق والواجبات، عبر أنظمة داخلية بمثابة دساتير للمدرسة، ومواثيق أخلاقية مؤطرة لتدخلات جميع الفاعلين، تؤكد على منع ولوج الأسلحة إلى المدرسة، وتوفير مناخ مدرسي يشعر فيه التلميذ بالأمان والانتماء، مع تكثيف برامج المواكبة والدعم النفسي والاجتماعي، وتدبير الغضب والصراع، وتعزيز ثقافة الإشراك والمساهمة في بناء القرار التربوي.
7. هل تتفقون مع أن الأسرة هي النواة الأولى لإنتاج العنف؟
هذا مرتبط بطبيعة الأسرة: هل تلجأ إلى معاقبة الطفل جسديا؟ هل تسمح له بمشاهدة ومعاينة نماذج عدوانية سواء داخل الأسرة أو خارجها؟ هل يتم إهماله ولا يتعلم السلوكيات المطلوبة اجتماعيا؟
إذا كان الأمر كذلك، فإن الأسرة تصبح القناة الأولى لتجسيد سلوك العنف، ومصدرا من مصادر إنتاجه. أما إذا كان العكس، فهي تساهم في تحصينه وحمايته مبكرا.
لكن المدرسة لا يجوز أن تكتفي بتشخيص مصادر العنف، بل من واجبها الانخراط في إيجاد الحلول من خلال برامج التربية الوالدية التي تجمع بين المدرسة والأسرة. وبالتالي، قد يكون هناك عنف أُسري، لكن المدرسة تملك القدرة والآليات لإعادة توجيهه وترشيده عبر وسائطها التربوية.
8. هل الإعلام مسؤول جزئيًا عن العنف في الفضاء التربوي؟
نعم، الإعلام قد يطبع أحيانا مع ثقافة العنف، إما من خلال المحتويات العنيفة التي ينشرها، أو المعالجة السطحية لأخبار الاعتداءات، أو تضخيم بعض الحالات لخلق نوع من الخوف والهلع في الأوساط الاجتماعية.
ولهذا، يجب أن يكون الإعلام شريكا تربويا للمدرسة في حملات التوعية والتثقيف، ناقلا للنماذج الإيجابية من داخل المؤسسات التعليمية، وداعما لمشاريع التلاميذ وقصص النجاح. وعليه، فالإعلام لا ينبغي أن يكون مجرد مرآة مجتمعية، بل فاعلا في تشكيل الوعي المدرسي وتحصين السلوك المواطن.
9. ما تقييمكم لمدى تفعيل النصوص القانونية التي تجرّم العنف داخل المدارس؟
بالطبع، هناك نصوص قانونية يمكن أن تفي بالغرض، لكن أعتقد أن الإشكال يكمن في ضعف آليات التبليغ والمتابعة داخل المدرسة، وتردد الأطر التربوية في استعمال النص القانوني، والاكتفاء بالإجراءات التربوية لإعطاء فرصة جديدة لأصحاب السلوكات العنيفة.
وأعتقد أننا اليوم مطالبون، انسجاما مع توجهات خارطة الطريق ومقتضيات القانون الإطار ومشروع قانون التعليم المدرسي، بمأسسة أنظمة اليقظة والاستشعار المبكر، وإرساء خلايا اليقظة والإنصات والوساطة، وتنظيم دورات تكوينية لمختلف المتدخلين لتجاوز مثل هذه السلوكات اللاتربوية بالنجاعة والفعالية المطلوبتين، مع الحرص على إدماج الثقافة القانونية في البرامج والمناهج، وإشراك المتعلمين في بناء بيئة مدرسية دامجة وآمنة، وتفعيل الأنشطة الموازية لإعطاء معنى للمدرسة والتعلم، والتقليل من مصادر التوتر والعنف والتنمر.
العنف المدرسي هو كل سلوك فردي أو جماعي يتسم بالعدوانية ويخل بالاحترام المتبادل داخل المؤسسة التعليمية، استنادا إلى نظامها الداخلي ومواثيقها في العمل، سواء كان موجها من التلميذ أو الأستاذ أو الإدارة أو الأسرة في بعض الأحيان.
ويشمل العنف اللفظي مثل: (سب، شتم، إهانة، تهديد، تنمر...)، والجسدي مثل: (ضرب، دفع، ركل، خنق، صفع...)، والرمزي مثل: (الإقصاء، التهميش، التمييز، التجاهل...)، والرقمي مثل: (نشر صور، تنمر إلكتروني، تشهير...).
أما تمظهراته فهي كثيرة ومتعددة، قد تكون رمزية في بعض الأحيان وتصل أحيانا أخرى إلى تمظهرات مادية، تتعدد أشكال وصيغ ممارستها، وتتنوع الجهات التي يقع عليها فعل العنف، فنجد مثلا عنفا بين التلاميذ، أو ضد الأساتذة أو بين بعضهم البعض، أو عنف الإدارة ضد التلاميذ، أو عنف الإدارة تجاه الأساتذة، أو الأسر تجاه الإدارة...
2. ما أبرز الأسباب البنيوية والاجتماعية التي تغذي هذه الظاهرة؟
إن سلوك العنف، الذي نشهده اليوم في مؤسساتنا عبر ربوع الوطن، عبارة عن ردة فعل إزاء واقع مرفوض ومتناقض مع الرغبات الذاتية أو الجماعية، بغض النظر عن مشروعية تلك الرغبات. ويعكس هذا السلوك نوعا من عدم الاعتراف بالعلاقات البيداغوجية وبأشكال السلطة التربوية كما هي ممأسسة ومنظمة ضمن إطار قانوني وتنظيمي.
إن العنف المدرسي، سواء كفعل أو كردة فعل، تتقاطع ضمنه مجموعة من العوامل: منها ما هو ذاتي، يحيل إلى التركيبة النفسية والبيولوجية والمعرفية للفرد، ومنها ما هو موضوعي، يحيل إلى المعطيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية.
ولا يمكن فهم هذه الظاهرة إلا بوضعها في سياقها الاجتماعي العام بأبعاده المختلفة، فالظاهرة تختلف حدتها وتمظهراتها باختلاف السياقات والأزمنة والأوساط المدرسية... ومن الطبيعي جدا أن تبرز هناك اختلافات وتضارب في وجهات النظر حول تفسير ومعالجة ظاهرة العنف المدرسي، لأن موضوع هذه الظاهرة هو الفرد، سواء كان تلميذا أو أستاذا أو إداريا... وهو ما يجعل منها ظاهرة إنسانية، تُنسج إما ذاتيا أو بتفاعل الذات مع مكونات المحيط الاجتماعي، حيث يمكن مقاربتها سواء بإعمال المنظورات الفردانية أو المنظورات الاجتماعية.
إلا أنه، في اعتقادي، ولكي تكون مقارباتنا مفيدة وإجرائية، لا بد أن تمتح من المنظور التكاملي الذي يجمع بين الجانب السيكولوجي والجانب الاجتماعي العام، مستحضرين في ذلك منطق الديناميات والتفاعلات الذي يجمع بين البعدين معا في زمان ومكان محددين. إن المقاربة النسقية تخبرنا بأن العنف داخل المدرسة ليس مجرد فعل معزول، بل نتاج لضعف التفاعل بين بنيات التنشئة الاجتماعية، وبنيات التأطير والمواكبة، وأزمات التماسك المجتمعي.
3. هل توافقون طرح أن تفشي العنف يعكس اختلالات أعمق في البنية المجتمعية؟ وكيف نفكك هذه الميكانيزمات؟
بكل تأكيد، إن تفشي العنف المدرسي ليس ظاهرة اجتماعية معزولة، بل يعكس اختلالات أعمق في البنية المجتمعية. فالعنف يتجذر في السياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعيد إنتاج اللامساواة والتهميش والضغط النفسي والإقصاء الاجتماعي.
وقد تناول عدد من المفكرين هذه المسألة من زوايا متعددة؛ حيث يرى بيير بورديو أن العنف الرمزي الذي تمارسه المؤسسات (كالمدرسة والإعلام) يكرّس الهيمنة ويعيد إنتاج الفوارق الاجتماعية ويحافظ على الوضع الاجتماعي بطبقاته وتمايزاته، أما إميل دوركايم فيربط بين غياب وضع لمعايير اجتماعية والعنف، بوصفه نتيجة لفقدان التوازن بين الفرد والمجتمع، ويحلل ميشال فوكو العنف بوصفه جزءا من آليات السلطة والرقابة التي تنتج أجسادا وعقولا مطيعة في المؤسسات.
ولهذا، فإن تفكيك ميكانيزمات العنف يمر عبر تحليل البنية الاجتماعية العامة، من خلال كشف علاقات السلطة، ونقد الأنظمة التعليمية والإعلامية، والتصدي للخطابات الإقصائية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. إن العنف، إذن، ليس سلوكا منحرفا فقط، بل هو مؤشر على أزمة بنيوية عميقة تتطلب إصلاحا شاملا يطال القيم والمؤسسات والفرص المتاحة للأفراد والجماعات.
وأعتقد أن تفكيك هذه الميكانيزمات، خاصة في علاقتها بالمؤسسة التعليمية، يمر بالضرورة عبر: دمقرطة الحياة المدرسية بتمكين المتعلمين من التعبير والمشاركة الفعلية في مشاريع المدرسة، وتأهيل الفرق التربوية لفهم العوامل والأسباب المغذية للعنف كسلوك يحتاج إلى معالجة نفسية وتربوية، وليس بالضرورة تأديبية، مع تنشيط آلية الوساطة المدرسية كآلية لحل النزاعات بشكل تربوي، والحرص على تحفيز المتعلمين على بناء مشاريع شخصية تعزز الشعور بالمعنى والانتماء، والتنسيق مع الأسر عبر مشاريع مؤسسية مشتركة للوقاية من العنف.
4. كيف تقرؤون نسب العنف في دراسات المجلس الأعلى للتربية؟ وماذا تعكس؟
أعتقد أن هذه الأرقام المقدمة في الدراسة المنجزة من طرف المجلس الأعلى ليست مجرد معطيات إحصائية، تبرز نسب العنف المرتفعة داخل المدرسة، ولا يمكن قراءة هذه المعطيات إلا من خلال منظور سوسيولوجي شمولي، يضع المدرسة في سياقها المجتمعي والثقافي والسياسي...إن الأرقام المقدمة إشارة واضحة لاختلالات بنيوية عميقة في النظام التربوي، وتعبير صريح عن توتر في العلاقة بين الفاعلين داخل المدرسة، وهشاشة بدأت تطال الإطار القيمي، والمشروع التربوي المشترك، وتآكل في السلطة التربوية. ولمواجهة هذا الواقع غير السوي، يتطلب الأمر مراجعة جذرية لهوية المدرسة، ولموقعها داخل المشروع المجتمعي العام. فحين تخفق المدرسة في أن تكون مجتمعا مصغرا للعدالة، فإنها تصبح مختبرا لإنتاج وإعادة إنتاج العنف. وهنا تبرز الحاجة إلى مقاربة شمولية تعيد الاعتبار لدور المدرسة ووظيفتها وعلاقتها بالبناء الاجتماعي العام، من خلال تأهيل الفاعلين والشركاء، وتطوير النموذج البيداغوجي، وتعزيز ثقافة الحوار، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والوساطة، بما يجعل من المدرسة فضاء آمنا للعيش المشترك، والتعلم، وبناء المواطنة.
5. هل تُعد الاعتداءات على الأطر التربوية مؤشرًا على فشل المدرسة في ترسيخ ثقافة الاحترام؟
نعم، وبكل تأكيد، عندما تغيب ثقافة الحوار، والمسؤولية، والالتزام، والقيم المشتركة، فهذا يؤشر على فشل المدرسة في تجسيد تربية وجدانية وأخلاقية فعالة. لكن هذا الفشل لا يجوز تحميل مسؤوليته للمدرسة فقط، بل يشمل ضعف التنسيق والتعاون بين المدرسة والأسرة ومؤسسات الإعلام وبنيات المجتمع. وأعتقد أنه مهما كانت المسؤوليات، فإننا بدأنا نشهد في السنوات الأخيرة تراجعا في الوضعية الاعتبارية للفاعل التربوي، وتقليصا في دوره التربوي، بالإضافة إلى التحولات التي طالت صورة المدرسة ووظيفتها، بحيث لم تعد ذلك المصعد الاجتماعي الذي يؤمّن الترقي الفردي والمجتمعي والحراك المهني. والتحدي الذي يواجهنا كدولة ومجتمع هو: كيف يمكن أن نعيد تأسيس مدرسة القيم والاحترام، لا مدرسة العقاب والخوف، في ظل سياقات الإصلاح التربوي المأمول.
6. إلى أي حد يسهم غياب الردع القانوني وسهولة الوصول إلى أدوات حادة في تكريس مناخ غير آمن؟
بكل تأكيد، غياب الردع القانوني الفعّال يضعف سلطة المؤسسة الرمزية، لكن الأهم، في تقديري، هو غياب آليات الوقاية والاستشعار المبكر داخل المدرسة.
وعليه، فإن الرهان ينبغي أن يكون على إعادة تنظيم التعاقد بين مختلف الفاعلين من خلال تحديد منظومة الحقوق والواجبات، عبر أنظمة داخلية بمثابة دساتير للمدرسة، ومواثيق أخلاقية مؤطرة لتدخلات جميع الفاعلين، تؤكد على منع ولوج الأسلحة إلى المدرسة، وتوفير مناخ مدرسي يشعر فيه التلميذ بالأمان والانتماء، مع تكثيف برامج المواكبة والدعم النفسي والاجتماعي، وتدبير الغضب والصراع، وتعزيز ثقافة الإشراك والمساهمة في بناء القرار التربوي.
7. هل تتفقون مع أن الأسرة هي النواة الأولى لإنتاج العنف؟
هذا مرتبط بطبيعة الأسرة: هل تلجأ إلى معاقبة الطفل جسديا؟ هل تسمح له بمشاهدة ومعاينة نماذج عدوانية سواء داخل الأسرة أو خارجها؟ هل يتم إهماله ولا يتعلم السلوكيات المطلوبة اجتماعيا؟
إذا كان الأمر كذلك، فإن الأسرة تصبح القناة الأولى لتجسيد سلوك العنف، ومصدرا من مصادر إنتاجه. أما إذا كان العكس، فهي تساهم في تحصينه وحمايته مبكرا.
لكن المدرسة لا يجوز أن تكتفي بتشخيص مصادر العنف، بل من واجبها الانخراط في إيجاد الحلول من خلال برامج التربية الوالدية التي تجمع بين المدرسة والأسرة. وبالتالي، قد يكون هناك عنف أُسري، لكن المدرسة تملك القدرة والآليات لإعادة توجيهه وترشيده عبر وسائطها التربوية.
8. هل الإعلام مسؤول جزئيًا عن العنف في الفضاء التربوي؟
نعم، الإعلام قد يطبع أحيانا مع ثقافة العنف، إما من خلال المحتويات العنيفة التي ينشرها، أو المعالجة السطحية لأخبار الاعتداءات، أو تضخيم بعض الحالات لخلق نوع من الخوف والهلع في الأوساط الاجتماعية.
ولهذا، يجب أن يكون الإعلام شريكا تربويا للمدرسة في حملات التوعية والتثقيف، ناقلا للنماذج الإيجابية من داخل المؤسسات التعليمية، وداعما لمشاريع التلاميذ وقصص النجاح. وعليه، فالإعلام لا ينبغي أن يكون مجرد مرآة مجتمعية، بل فاعلا في تشكيل الوعي المدرسي وتحصين السلوك المواطن.
9. ما تقييمكم لمدى تفعيل النصوص القانونية التي تجرّم العنف داخل المدارس؟
بالطبع، هناك نصوص قانونية يمكن أن تفي بالغرض، لكن أعتقد أن الإشكال يكمن في ضعف آليات التبليغ والمتابعة داخل المدرسة، وتردد الأطر التربوية في استعمال النص القانوني، والاكتفاء بالإجراءات التربوية لإعطاء فرصة جديدة لأصحاب السلوكات العنيفة.
وأعتقد أننا اليوم مطالبون، انسجاما مع توجهات خارطة الطريق ومقتضيات القانون الإطار ومشروع قانون التعليم المدرسي، بمأسسة أنظمة اليقظة والاستشعار المبكر، وإرساء خلايا اليقظة والإنصات والوساطة، وتنظيم دورات تكوينية لمختلف المتدخلين لتجاوز مثل هذه السلوكات اللاتربوية بالنجاعة والفعالية المطلوبتين، مع الحرص على إدماج الثقافة القانونية في البرامج والمناهج، وإشراك المتعلمين في بناء بيئة مدرسية دامجة وآمنة، وتفعيل الأنشطة الموازية لإعطاء معنى للمدرسة والتعلم، والتقليل من مصادر التوتر والعنف والتنمر.
الأستاذ عبد العزيز سنهجي (خبير تربوي)